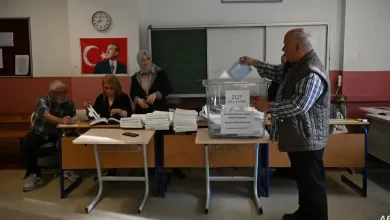العالم يغرق في مستنقع الأنانية والعنصرية الجزء الثالث

بقلم: محمد أمين المصري-
من رواية “السيد آدم” الخيالية إلى الواقع المأساوي الذي يعيشه العالم الآن في عصر فيروس “كورونا”، لم تختلف الأوضاع كثيرًا، فنجاة الرجال في عصر آدم جاءت بفضل التوصل إلى عقار عشبي، لولاه لما نجا البشر، ولماتوا جميعًا في غضون سنوات، ولهلك العالم بلا رجعة، إلا أن يشاء المولى عز وجل أمرًا آخر.
وكلنا يعلم قصة آدم أبي البشر – عليه السلام – الحقيقي، لكن قلة يعرفون قصة “هومر آدم” الذي أراده الأمريكيون أبًا لكل أجيالهم المقبلة، وقد أصبح بين عشية وضحاها حديث الأمريكيين والعالم أجمع، نظرًا لما اختصته به الطبيعة من قوة خيالية، تكفي لتخصيب نساء بلاده، وغيرهن من نساء البشر؛ إذا أرادت الإدارة الأمريكية ذلك.
في عصر “هومر آدم”، اقتربت البشرية من نهايتها، وهم يقولون هذا الآن: “لقد اقتربت حياة الإنسان من الفناء بسبب الفيروس العضال الذي لا علاج فعال له حتى الآن”.. فهل أوشكت نهاية العالم حقًا بعد ارتكاب البشر والمجتمعات والدول والكتل الموبقات كافة؟
إن العالم الأول الذي يدعي التحضر قد أقرض دول العالم الثالث مليارات الدولارات ليس ليضعها في المسار الصحيح، وإنما لينهبها ويحلب خزائنها ومواردها لتعيش في فقر مدقع أبد الآبدين.
قصة “هومر آدم” وفيروس “كورونا”
مرض الذكورة الأمريكية في قصة “هومرآدم”، يشبه ما فعله فيروس “كورونا” في العالم، فانفجار المسيسبي الذري أتى على خصوبة الرجال فأضاع حلم الأمومة لدى النساء، وكذلك أتى فيروس “كورونا” علي قيمة “الإنسانية” ليندثر الأمل في غد آمن، فالحياة قد توقفت تمامًا حتي في أعرق الدول الرأسمالية سواء بفعل مؤامرة أو بدونها، فكل قيادات العالم بلا استثناء قررت وقف عجلة الاقتصاد، ليس لعلاج الوباء، ولكن خوفًا من انتشاره، ورغبًة في حصاره، لكنه واصل حصد الأرواح، فلا هرب إنسان من مصيره، ولا نجت حكومة من آثاره الاقتصادية المدمرة..
وبمناسبة المؤامرة، فقد حفزت أزمة فيروس “كورونا” نفس النظرية، بل تضخمت، فهناك من ادعى أن الفيروس هو سلاح بيولوجي أجنبي أو اختراع حزبي، أو جزء من مؤامرة لإعادة هندسة سكان العالم. وثمة من اعتقد أن بيل جيتس قطب التكنولوجيا ومؤسس شركة “مايكروسوفت” هو الذي خطط لهذا الفيروس نيابة عن شركات الأدوية. وفي أمريكا اللاتينية سرت شائعات بأن الفيروس سيؤدي إلى نشر فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، في حين استغله رجال الدين في إيران ليصوروه علي أنه مؤامرة غربية على بلادهم المستقرة!
فالفيروس شابه انفجار “المسيسبي”، حيث افتقد العالم آنذاك السلاح الذي يعيد به للرجال خصوبتهم التي قضي عليها الإشعاع الذري، وكذلك “كورونا” الذي يواجه العالم وهو أعزل من العلم والسلاح!
النجاة من الهلاك
في مواجهة فيروس “كورونا” ومتحوراته من دلتا الي أوميكرون، لجأ الإنسان إلى حيل طبية للنجاة أو في محاولة للنجاة، الأمر الذي أدى إلى زعزعة استقرار دول كنا نراها قوية ومتقدمة، بعد أن وقفت قليلة الحيلة أمام زلزال الفيروس الذي قضى على شركات وحكومات ودول، بل قضى على مفهوم العولمة والحداثة، وما بعد الحداثة، فكان الإنسان الضحية الكبرى له، كما كانت خصوبته الضحية الأكبر أيضًا لانفجار “المسيسبي”.
وكما شعرت المرأة في قصة “آدم” بالحزن لأنها باتت تشعر بالوحدة والعزلة، ولم تعد تحلم بكلمة “ماما” وممارسة الأمومة التي هي أغلى ما تتمناه كل امرأة، ترك لنا فيروس “كورونا” العزلة والوحشة والموت، إذ كانت “العدادات” لا تتوقف يوميًا عن إحصاء الإصابات والوفيات، حتى امتلأت الصحف بعناوين من مثل: “يوم الإغلاق العظيم.. الكارثة تحل بأوروبا.. الأمريكيون يتفوقون على العالم في عدد الإصابات والوفيات”.. ألخ.
وكما فشلت الإدارة الأمريكية والجيش الأمريكي والمؤسسة القومية لإعادة الإخصاب في حماية “آدم” من نفسه ومن طمع الكل في خصوبته، فشل كل ما حققه العالم من علم وكل جوائز نوبل العلمية والطبية، في حماية الإنسان من براثن فيروس خفي يملك أعتى أنواع الأسلحة التي لم تجد ما يواجهها حتى الآن، مما يدعونا للقول إن كل هذا التقدم لم يمنح الإنسان السكينة والاستقرار.
فشركات الأدوية – التي راكمت ثروات هائلة من مبيعاتها – فشلت في توفير ما يحلم به الإنسان البسيط من نوم هادئ.
وكما ضاعت خصوبة رجال الولايات المتحدة والعالم بتأثير انفجار ذري، ستنزوي عن العالم شخصيات ملأته ضجيجًا ولم تعد تجدي نفعًا مع وجود هذا الوباء الغامض المجهول. فالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه أصبح أسير تغريداته، ولم يقدم – لا هو ولا بلاده – علاجًا ناجعًا للمرض الكوني، بل وقع هو نفسه أسيرًا للمرض، اللهم سوى التوصل الى بعض أنواع اللقاحات المضادة للفيروس ومتحوراته.
ففي حين اعتقد العالم كله أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك “دواء لكل داء”، حلَّ الداء بأجساد البشر بينما غاب الدواء، وظل ترامب، ومن علي شاكلته من زعماء العالم؛ تائهًا يسابق هو وغيره الزمن ليكون له “السبق” في كشف الدواء، ليقول: “أنا الأقوى”، لكننا سنبقى طويلًا بدون هذه الكلمة، ليعيش الإنسان حائرًا بعدما أدرك أن العالم الذي يعيشه بلا أبطال خارقين، كما كان يعتقد من قبل، إذ كل ما يعيشه زائف، وتضيع معه شخصيتا “رامبو وروكي” الأمريكيتان، فعالم هوليوود اخترع القوة الأمريكية على الشاشة، لكن الواقع أثبت أن الأمريكي مجرد إنسان عادي في مواجهة “كورونا”، وما حوله.
مشاهد النهار في كوابيس الليل
في قصة “السيد آدم”، داهمت الكوابيس ليالي السيدات، فتلاشت الأحلام الورية، وحلَّ مكانها الخوف مما كن يرونه في كوابيسهن من القضاء علي البشرية، وانتهاء حياتهن بدون كلمة “أمي” أو ممارسة الأمومة.. مهما كانت مرهقة نفسيًا وروحيًا علي بعض السيدات، فالأمومة من ضمن مكونات الأنوثة بطبيعة الحال.
أما في عصر “كورونا”، فالكوابيس قضت على أحلام الجميع، ذكورًا وإناثًا، كبيرًا وصغيرًا، ولم ترحم أحدًا، فكان كابوس الإصابة بفيروس “كورونا” الوافد الليلي للبشر مع المرور بمتاعبه النفسية والجسدية على مدى فترة الكابوس الليلي.
فما جاء ليلًا ليس سوى نتيجة تفكير طويل في خلال ساعات النهار، فالأحلام والكوابيس ما هي إلا انعكاس لأفكار اليقظة، فما نراه ظهرا وعصرا يهاجمنا ليلا في أحلامنا، وهذه وظيفة العقل الباطن الذي يخزن الوقائع لرؤيتها ليلًا، أو يكشفها مقدمًا إلى حين تأتي لاحقًا. والنتيجة الأهم لمثل هذه الكوابيس هي تلازم سير الحياة مع الخوف، وعدم الفكاك منه، فالخوف والفزع لم يعد شعورًا وقتيا بل أصبح دائمًا.
العودة للدين والذات
مثلما كان الحال صعبًا وقاتمًا على الأنفس في زمن “هومر آدم”، خلال أزمة ما بعد انفجار “المسيسبي” في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو الأمر ذاته، وربما أصعب في زمن “كورونا”، فأيامه ليست مرغوبًا فيها تلك التي يعيشها البشر حاليًا في ظل إجراءات وقائية صارمة يصعب الفكاك منها، فمن يحاول تفاديها مصيره المرض لا محالة أو هكذا يقول أهل الطب والحكومات، حتي وإن خفت قبضة الحظر المتدرج في الدول.
ومن عالم “عصر آدم”، حيث بشر بفناء الأمومة، وعدم رؤية مولود جديد في الولايات المتحدة والمعمورة، جاءت جائحة “كورونا” برؤية سوداوية تنذر بفناء البشرية ذاتها، ليس بعد حين كما في “عصر آدم”، وإنما في غضون فترة زمنية أقل مهما حدثنا الأطباء والعلماء، بدليل تخلي الناس عن ارتباطهم بالعلم، ولجوئهم إلى الدين والموروثات الشعبية كعلاج نفسي وعضوي من ويلات الوباء، وكذلك التفكير في مرحلة ما بعد الموت أو يوم القيامة الذي اعتقدوا أنهم قد اقتربوا منه جدًا، فما لهم من نجاة سوى باللجوء إلى الله، لعلهم يكونون من المُبشرين بالجنة.
فقد أتتهم فرصة التصدق وعمل الخير والعودة إلى الله والإيمان، والمسارعة إلى إعلان شهادة “لا إله إلا الله.. محمد رسول الله”.
هكذا فعل المؤمنون، وبرغم الوباء وويلاته، إلا أنه من رحم النكبة الصحية، خرج البشر إلى الأمل، فكان الدين هو الملاذ لهم، ضد الكوارث، في كل العصور.
في “قصة آدم”، لجأ الناس إلى الدين لعل الله يرسل شفاءه للرجال، ويعيد النسل من جديد في أرضه، وهكذا فعل الكثيرون في زمن “كورونا”، إذ اقتربوا من المولي عز وجل لعله يهديهم سُبُل الرشاد، والنجاة من المهالك.
وليس غريبا أن يلجأ الإنسان إلى الدين أو موروثاته الشعبية مهما تقدمت الدول والممالك، فالبعد الروحاني يطفو في مثل هذه النكبات في المجتمعات كافًة، فقيرة أو غنية، متحضرة كانت أم متأخرة، علمانية كانت أم دينية.
والهدف من هذا اللجوء إلى الله أو الدين، لهو دلالة على القلق واليأس الذي يشعر به الفرد حيال الوافد الجديد، الخفي الجبار، ناهيك عن هروب قسري من حياة ربما يراها الإنسان منفلتة من عقالها الأخلاقي بعد ما أسرفت الشعوب والدول في تعظيم الذات، ونسب كل تقدم للفرد، والابتعاد عن الله.
ولهذا، وفي خلال الأيام الأولي للوباء، كشفت شرائح عريضة من البشر عن غضبها من العلم الحديث، فلجأوا إلى خالقهم مباشرة طلبا للشفاء والرحمة والمغفرة من بلاء ابتعادهم عنه وتعاليمه ودينه.
ولم تكن العودة إلى الرب مفاجئة، فهي عادة بشرية تحدث دوما وقت الملمات والنكبات، فالنجاة هي بالالتجاء للمولى عز وجل.
ووفقا لبيانات شبه رسمية – تم الاستعانة بها من مصادر متعددة – كان هذا حال البشر حين داهم وباء الجدري شعوب الكرة الأرضية في القرنين الخامس عشر والسابع عشر، والكوليرا (1817ــ 1823)، والإنفلونزا الإسبانية التى حصدت أرواح نحو خمسين مليون شخص على مستوي العالم (1918ــ 1919)، بخلاف إصابة نحو خمسمائة مليون شخص آخرين بها.
الغناء في زمن الطاعون
هكذا فعل الأوروبيون عندما لجأوا للدين وقت وباء “الطاعون الدبلي” (1347ــ 1350) المعروف بـ”الموت الأسود”، الذي أهلك ثلث سكان القارة الأوروبية وقتها.
ففي ذاك الزمن، لم يخل الأمر من خيالات كاتب حولها المخرج العالمي إنجريد برجمان إلى عمل سينمائي رائع باسم “الختم السابع The Seventh Seal”.. ففي منتصف القرن الرابع عشر، يعود “أنطونيوس” قائد جيش السويد المشارك في الحروب الصليبية مع مساعده “جينيس” بعد عشر سنوات من المعارك إلى الوطن، وقد نجا الرفيقان طوال تلك الفترة بأعجوبة من ويلات الحرب إلا أنهما عادا إلى بلدتهما ليكتشفا انتشار وباء قضى على أجساد البشر وجعل البلاد كلها مقفرة ومظلمة من شدة البؤس، فالدمار هو الوصف الأبرز للوطن الموبوء.
وبينما يستفيق “أنطونيوس” من غفوته الطويلة وهو على مشارف بلدته علي شاطئ بحر، ويهم برص قطع الشطرنج حتى يفاجأ برجل غريب الأطوار يتجلى أمامه وجها لوجه، يرتدي عباءة سوداء تغطيه من رأسه حتى قدميه ولا يخرج منها سوى وجهه بملامح باردة ويكاد يكون وجهه متجمدا، فيسأله “من أنت؟” فيرد: “أنا ملك الموت كنت بجوارك منذ فترة طويلة”..ثم يبلغه بأن يرحل معه حيث أزف وقت مغادرته الحياة.
لم يدرك “أنطونيوس” حجم المفاجأة، وسأل ملك الموت:”هل جئت من أجلي؟”، ورد ملك الموت بالإيجاب، وعبثا حاول إقناع الفارس العائد من الحرب بحلول موعد موته، ولكن “أنطونيوس” من جانبه، حاول منح نفسه فرصة أخرى للحياة طالبا من ملك الموت تأخير قبض روحه عارضا عليه أن يلعبا شطرنج، وإذا فاز فيصير من حقه منحه فرصة أخرى للبقاء حيا غير مقبوضة روحه.
لم يكن مطلب “أنطونيوس” من ملك الموت رغبة منه في زيادة سنوات عمره أياما أو شهورا أو سنوات، فالوطن الذي عاد إليه لا يستحق الحياة فيه، فكل ما به بؤس وشقاء وأمراض وعدوي وموت أسود يلتهم الأرواح بالجملة، لدرجة تصيب أي عاقل بالجنون..ولكن رغبة “أنطونيوس” الحقيقية في تأخير قبض روحه كانت الحصول على إشارة يهتدي بها، أو شئ يضِيء له ظلمة القبر الأبدي الذي يتخيله عن حياة ما بعد الموت، والأهم هو ممارسة طقوس “الاعتراف” لدى كاهن الكنيسة.
اقتنع ملك الموت بلعب الشطرنج، وتمت المباراة وفاز “أنطونيوس” الماهر في اللعبة، وكتبت للفارس العائد حياة أخرى، ثم يذهب الى الكنيسة من أجل الاعتراف والحصول على حقائق لما بعد الموت، في حين انتظره مساعده “جينيس” في موقع آخر بالكنيسة، وقضى وقته يتحدث مع رسام اللوحات بالكنيسة، وأبدى انزعاجه من الرسوم المخيفة على جدرانها، ليستفسر من الرسام عن سر تجسيد مثل هذه اللوحات المرعبة على جدران أماكن العبادة؟..فيرد :”إنها رقصة الموت”.. ويتساءل “جينيس” مجددا: “ولماذا كل تلك النقوش؟” فيرد الرسام:” ليتذكر الناس الموت”.
رقصة الموت
تجسد لوحة “رقصة الموت” في الفيلم السينمائي “الختم السابع The Seventh Seal”، البشر وهم متشابكو الأيدي وخلفهم هياكل عظمية خلال وصلة رقص، كدلالة على النهاية الحتمية للبشر، وهو المشهد الذي ينتهي به الفيلم ولكن أضيف إليه ملك الموت ممسكا بيد الفارس الذي يمسك يد مساعده، وهكذا في الموقف مع الآخرين، ليأخذهم معه في رقصة أبدية.
تنتقل المشاهد في هذه الأُثناء لنري “أنطونيوس” يقف أمام غرفة الكاهن ليعترف له بخطاياه خلال الفترة الماضية، وبينما هو يسرد موبقاته أدار الكاهن له رأسه ليكتشف “أنطونيوس” أنه ملك الموت نفسه ليبلغه أنه بعد كل هذا لم يقتنع بعد بحلول موعد رحيله عن الحياة، مضيفا: “أغلب البشر وأنت منهم لا يؤمنون بالموت والعدم إلا عندما يحين موعد قبض أرواحهم”.
الناس تلجأ للدين والجذور في وقت الملمات، ولكننا نراهم يبتعدون في الوقت نفسه عن رجال الدين، وربما يطرح “The Seventh Seal” عبر مشاهده فكرة مهمة هي:”لماذا لا يتركنا رجال الدين سعداء ولماذا يذكروننا دائما بجهنم والموت؟ وما الذي يجعلهم فرحين بهذا؟”.. في حين أن مهمة رجال الدين هي حمل مشاعل النور والأمل في النفس البشرية حتى في رمقها الأخير، ونشر قيم ومبادئ المحبة والإخاء وجعل الحياة أكثر سعادة مع التذكير بالموت في آخر الأمر، في حين نجد أن رجال الدين – وبينما يحصد الطاعون (الموت الأسود) معظم أرواح السكان – يتوعدون الناجين بالموت: “كل ما يحدث لكم هو عقاب مستحق من الرب”، وكأن مهمتهم في الدنيا استغلال التفويض الإلهي لهم لمحاكمة البشر والحكم علي نهايتهم بصورة قاطعة لا تقبل المناقشة، وبشكل ينغص على الناس عيشتهم وحياتهم.
في وقت الطاعون، كان العنوان الأبرز هو “الأنانية” – مثلما الحال وقت قصة “السيد آدم”، وعصرنا الراهن، ومع انتشار فيروس “كورونا” ومتحوراته – حيث سعت جماعات بعينها ودول الى الاستئثار بالتلقيح الصناعي واللقاحات الخاصة بعلاج “كوفيد 19”.
فبينما تمر أحداث “The Seventh Seal”، تتاح فرصة أمام “جينيس” لأخذ فتاة لتعمل خادمة عنده، وبينما تسير القافلة تلتقي بأحد المرضى الذي يطلب منهم شربة ماء لعلها تشفيه من أوجاعه، ويتهرب الجميع منه باستثناء تلك الفتاة التي حن قلبها إليه لتقترب منه لكي يشرب من وعائها، فيخبرها سيدها “جينيس” أن فعلها هذا بلا معنى فالرجل يموت و”شربة مائك لن تبقيه على قيد الحياة”، في دلالة على أنه عندما يأتي الموت فلا تفكر في غيرك، وكأننا أمام بعض آيات سورة عبس: “فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37)”.
تمر أحداث الفيلم لنرى بموازاة مشاهد “أنطونيوس وجينيس”، عربة خشبية مغطاة على شكل خيمة يجرها حصان، وهي مقر سكن ومعيشة وتنقلات لإثنين من مهرجي السيرك وزوجة أحدهما وطفلهما، ويعكس وجودهم في الفيلم التعبير عن الأمل واستمرار المرح والفكاهة.
فالموت، وإن كان البشر قد اقتنعوا به كنهاية لحياتهم، إلا أن الفن يبقى برسالته الممثلة في الغناء تارة وأداء الأدوار الهزلية تارة أخري.. فغناء زوجة المهرج لكلمات من أشعاره وموسيقى آلته جعلت الفارس “أنطونيوس” ينصت لها بحب، ليشعر بلحظات من الهدوء النفسي جعله ينسى، ولو مؤقتا، فكرة أن ساعة موته قد قربت، وينعم بمشهد الزوجة والزوج وطفلهما الذين ينعمون بالطمأنينة والسكينة برغم فقرهم.
فالغناء والتمثيل ضرورة للحياة في مواجهة البؤس والشقاء والمرض والموت، فهو الأمل لمجابهة اليأس، وما أدراك ما اليأس، في وقت اجتاح فيه الطاعون (الموت الأسود) الذي قضى على البشر في حوار جاء على لسان أحد الممثلين قال فيه :”الناس تموت كالذباب..أنه يوم الحساب، فالملائكة تنزل الأرض لتفتح القبور، الأمر بات فظيعا”.
أيا كان موقف فيلم “The Seventh Seal” من التوجه الإيماني لأبطاله باستثناء رغبة “أنطونيوس” في الاعتراف للكاهن بذنوبه قبل موته، فإن ما حدث وقت “كورونا” و”دلتا” و”أوميكرون” و”آدم” يدل على يقين الإنسان بديمومة العامل الإيماني والروحي على مستوى البشر كطبيعة أصيلة في الحضارة الإنسانية، على الرغم من كل ما امتلكه الإنسان الحديث من تكنولوجيا وعلم ومعرفة وأسلحة فتاكة وإنترنت وعالم لا متناهٍ من مواقع التواصل الاجتماعي “سوشيال ميديا”، وأفلام هوليوودية عن سوبرمان والوطواط وروكي والبطل الخارق وخلافه. فالإيمان ثقافة دائمة لا يقهرها علم وخلافه، لأنه أصل الحضارة.
وفي زمن الوباء، يفتح الإنسان صفحة جديدة في حياته، ليس ليطوي معها صفحاته القديمة، ولكن ليعود من خلالها إلى ضوابط أخلاقية تحلى بها الإنسان القديم، لكنها تعرضت للانهيار بسبب الثورة العلمية، بموبقاتها الأخلاقية، وتراجع الجانب الروحي والإيماني معها للإنسان الذي استسلم لواقع علمي اعتقد أنه منجاة من كل نائبة.
فمن فوائد زمن “كورونا” عودة الإنسان إلى أصوله، حيث أدرك أن هذه العودة فيها خلاص للإنسانية من مأساتها، فكانت العودة إلى الهوية لزمة حياتية بعد أن تخلى عنها البعض ليندمج في ركب المجتمع الحديث أو ليقال عنه ذلك علي سبيل التحضر والشعور بأنه حر، علي اعتبار أن الحرية في الزمن الحاضر تقتضي التخلي عن الهوية الأصلية والحضارة والتاريخ والدين وثقافة الماضي والقومية. ولكم خابت هذه النظرية في زمن “كورونا”، ولعل هذا من فوائد النكبة الفيروسية للبشرية.